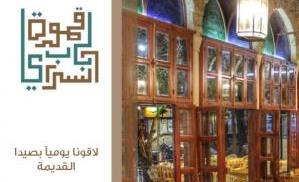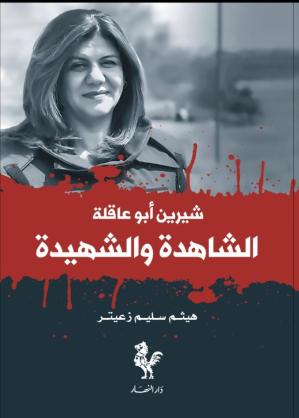اقتصاد >اقتصاد
"اقتصاد الرغبة" من يحرّك "شهية المستهلك" في عصر الترند؟

لبنى عويضة
في زمن السعار الاستهلاكي، لم يعد الاستهلاك فعلًا اقتصاديًا بحتًا، بل تحوّل إلى نمط وجود. إذ أن الفرد لم يعد يشتري ما يحتاج، بل يُدفَع دفعًا نحو الرغبة، ثم اللهاث، ومن بعدها الارتهان. وهذا السعار لا ينشأ من فراغ، بل يُدار كصناعة مستقلة بوساطة من يتقنها، ألا وهم “تجّار العقول”.
حين يتحوّل العقل إلى سوق مفتوح
هؤلاء لا يبيعون سلعة، بل يبيعون فكرة، رغبة، شعورًا بالنقص؛ يتسلّلون إلى اللاوعي، يحرّكون أوتار النفس الخفية، ويستثمرون في خوف الإنسان من الشيخوخة، من العزلة، من الفشل، ومن شعور عدم الكفاية. فلم تعد الإعلانات واجهات للعرض في عصر السوشيال ميديا، بل أدوات هندسة نفسية دقيقة. ويُسخَّر لها علم النفس السلوكي، التسويق العصبي، تقنيات الإيحاء والتكرار. وبواسطتها، يصبح المستهلك مدفوعًا بقوة لا يراها، لكنه يطيعها.
“كن أنت، عبر هذا العطر.”
“انضم للنخبة، بارتداء هذه الساعة.”
“تألّق، تميّز، استحقّ الحب.”
كلّها شعارات لا تخاطب العقل، بل تزرع نقصًا وهميًا، وتبيع وعدًا هشًّا بالاكتفاء.
الهوية كسلعة: من أنت بلا ما تملك؟
الخطير في الأمر أن السوق لم يعد يقدّم منتجات فقط، بل يعيد تعريف الإنسان من خلالها. وتصبح الهوية نفسها قائمة على ما نستهلكه.
نشتري لنعوّض شعورًا باللاجدوى.
نلبس لنهرب من هشاشة الداخل.
نُقارن، نُقلّد، نُلهث وراء معايير وُضعت لنبقى دومًا غير مكتملين…
وكلّما زاد الاستهلاك، قلّ الاكتفاء.
في قلب المتاهة: اللعب النفسي لا يتوقّف
تضاعف منصات التواصل الطوفان. المؤثرون، الترندات، التحديات اللحظية… كلها تُعيد إنتاج السعار بأشكال يومية:
كلما ظننت أنك امتلكت، يظهر ما يجعلك ناقصًا من جديد.
كلما حاولت الانسحاب، تُغريك صورة، صوت، أو وعد جديد.
ومن هنا تتحوّل الجهة النفسية إلى أرض محتلة. لذا، لا عجب أن نستهلك أكثر مما نملك، ونقترض لنشتري، ونقتطع من حاجاتنا لنلحق بترند عمره ساعات.
هذا ليس ترفًا، بل مفعول قصفٍ نفسي مدروس.
الترند كقيد ذهبي: عندما يصبح المنتج مؤقتًا بحجم جنون دائم
ما يُفاقم هذا السعار هو منطق “المنتجات الترند”: سلع لا تُصمَّم لتدوم، بل لتُشعل موجة وتنطفئ سريعًا. هي سلعة بلا جوهر، لكنها تُلبَس قناع الضرورة، عبر ضجيج السوق وصراخ المنصات. فيُسوّق للمنتج كأنه خلاص مؤقت:
• سوار يزعم تنقية الطاقة
• مشروب يعدّل المزاج
• قطعة ملابس تصبح رمزًا للانتماء
• جهاز لا وظيفة له إلا أن يُقال: “أنا أيضًا أملكه”
وبالتالي تدخل في دوّامة “الاحتراق النفسي الاستهلاكي”: تشتري لتلحق، تلحق لتبقى، تبقى لتُرى. وكلّ ذلك على حساب المال، الوعي، والاتساق الداخلي.
الترند لا يخلق حاجة، بل يُخترع ليشبع وهم الحاجة، ويختفي قبل أن تسأل: لماذا اشتريته أصلًا؟ ولأن الترند سريع الزوال، تصبح الضحية دائمة السعي. ويتضح أنه جوع لا يُشبع، لأن الجوع نفسه هو البضاعة.
أما من أبرز الأمثلة على جنون الترند في الوقت الراهن نذكر
:Labubu دمية بلا وظيفة، تحوّلت إلى رمز نفسي زائف فقط لأنها ظهرت في فيديوهات مشحونة عاطفيًا.
زجاجات Stanley وHydro Flask : ليست أدوات شرب فقط، بل شيفرات انتماء. بالإضافة إلى عطور، أجهزة، مشروبات، ملابس “ضرورية” تظهر فجأة وتختفي دون أن تترك أثرًا حقيقيًا… إلا في الجيب.
من الرغبة إلى الأرباح: حين تُستثمر الغرائز وتُهندَس الأسواق
هذا الاقتصاد القائم على الرغبة لا يعمل في الفراغ. بل هو ركيزة أساسية للرأسمالية الحديثة، التي لم تعد تعتمد على الحاجات، بل على إنتاج رغبات قابلة للاستثمار. وكل موجة استهلاكية تُترجم إلى أرباح آنية للشركات، لكن بتكلفة طويلة الأمد على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ففي هذا النموذج، تُصمَّم المنتجات لتفقد قيمتها بسرعة، ويُعاد تدوير الرغبة بذكاء لا يعرف الرحمة. إذن، الطلب لم يعد نابعًا من الحاجة، بل من الإيحاء الجماعي المتواصل.
والنتيجة؟
توسّع وهمي في الإنفاق الفردي، يقابله ارتفاع في مستويات الدين والاستهلاك القسري. ودورات اقتصادية هشّة قائمة على “الضجيج” لا على القيمة. ضف إلى ذلك تلاشي الطبقة الوسطى بين ضغوط التقليد ومتطلبات اللحاق بالترند.
وبينما تتضخّم ثروات عمالقة السوق، تُستنزف الجيوب، وتُجهض إمكانيات الإدّخار، ويُعاد تشكيل الاقتصاد العالمي على قاعدة: كلما استهلكت أكثر، أصبحت أقل حرية.
بين السعار والغفلة: أين المناعة؟
السوق شرس، نعم.
الإعلانات مدروسة، صحيح.
لكن الأخطر أن الفرد نفسه بات بلا مناعة. فلا التربية، ولا التعليم، ولا الإعلام يوفّر أدوات وعي أو دفاع. بل على العكس، يكرّس المجتمع فكرة أن الإنسان يُقاس بما يملك، لا بما يفكّر.
وفي ظل غياب المناعة النفسية والثقافية، يتحوّل الإنسان إلى وعاء مفتوح تُسكب فيه الرغبات المصنّعة. وينسى أن يسأل، أن يختار، أو حتى أن يرفض.
وهكذا، لا يعود الفرد مجرّد مستهلك… بل يصبح هو نفسه المنتج.