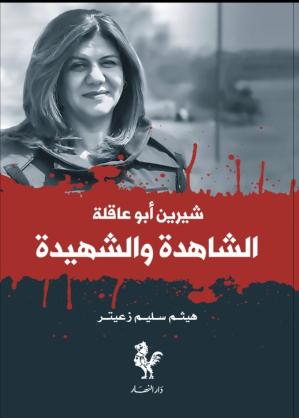بأقلامهم >بأقلامهم
هل بالإمكان تعويضُ "الفاقد التّعليميّ" فيما تبقّى من العام الدّراسيّ الحاليّ؟

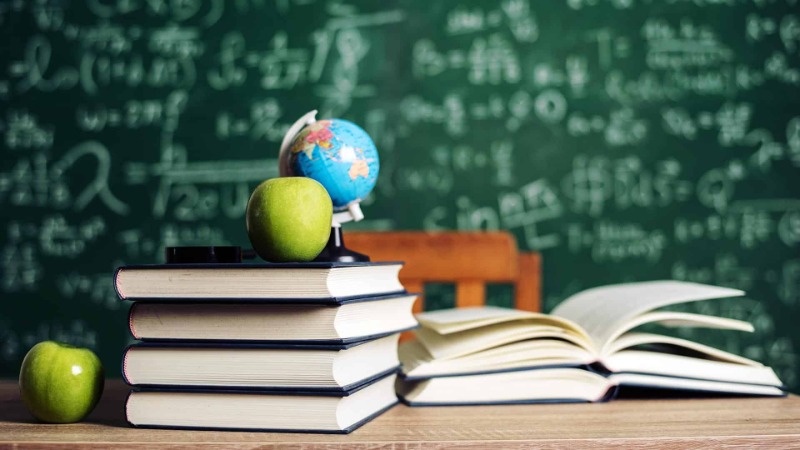
جنوبيات
تُعرّف اليونسكو "الفاقد التّعليميّ" بأنّه فُقدان المهاراتِ الأساسيّة التي كان ينبغي على كلّ طالبٍ أن يمتلكَها في مرحلة تعليميّة مُعيّنة". وقد أَدخلت هذه المُشكلة العالمَ في حيرةٍ من أمره أمام الضّياع الذي تتعرّض له أجيالٌ بكاملها جرّاء هذا الفاقد؛ لِما له من أبعادٍ خطيرةٍ وهيكليّة على مستقبل التّعليم، ليس أقلّها التّسرّب، وتدنّي الدّافعيّة، وارتفاع نسبة الأمّيّة، والتّعثّر التّعليميّ.
إنّ الحديثَ عن الفاقد التّعليميّ في لبنان لا يستقيمُ من دون الحديث عن وجود أزمةٍ حقيقيّة في العمليّة التّعليميّة. وعند التّطرّق إلى قضيّة شائكة مثل "الفاقد التّعليميّ"؛ فنحنُ لا نتناول الحديث عن إجراءاتِ تعويض هذا الفاقد بمعزلٍ عن تحسين العمليّة التّربويّة بمُجملِها. ذلكَ أنّ التّعليم الوجاهيّ لم يستطع حتّى اللّحظة ترميم الشّروخ والتّشوّهات التي أحدثها التّعليم الافتراضيّ، الأمر الذي سبّب هدرًا تعليميًّا واسِعًا لم تعد تنفع معه التّدخّلات العلاجيّة الاعتياديّة. وفيما يلي طائفةٌ من الحلول التي نعتقدُ أنّها قد تُسهمُ، بدرجةٍ أو بأخرى، في علاج هذه المُعضِلة:
١- دراسة أبعاد المُشكلة بصورةٍ موضوعيّة، من خلال تحديد نسبة الفاقد التّعليميّ لدى التّلامذة في كلّ مادّة عبر أدوات قياس تربويّة فعّالة.
٢- تحليل المُحتَوى التّعليميّ للمادّة التي حدث فيها الفاقد، وإعداد مصفوفة المفاهيم والمعارف والمهارات الأساسيّة التي تحتويها هذه المادّة.
٣- إعداد خطّة مُجدوَلة تتضمّن مؤشّرات الفاقد التّعليميّ، وأدوات التّدخّل، والوسائل المُساعِدة، وأدوات التّقويم، والمُدّة الزّمنيّة.
٤- زيادة مدّة التّدريس، كإضافة ساعاتٍ إلى ما بعد الدّوام الفعليّ، أو في عطلة نهاية الأسبوع، أو في الإجازاتِ الموسميّة، لتعويض أكبر قدرٍ مُمكن من الفاقد التّعليميّ، على أن تُخصّص هذه السّاعات المَزيدة لتدعيم المهاراتِ الأساسيّة في المادّة ومُمارسة تدريبات وتطبيقات مُكثّفة عليها.
٥- إعطاء الأولويّة للّغتين العربيّة والإنجليزيّة والرّياضيّات، وزيادة المدّة الزّمنيّة المُخصّصة لها، وبالأخصّ في الحلقة الأولى. فهذه الموادّ الثّلاث هي الأساس في الانطلاق نحو التّعلّم، وهي الرّكيزة الجوهريّة في تكوين شخصيّة الطّالب.
٦- تقليص المناهج المدرسيّة بما يُؤدّي إلى التّركيز على الأساسيّات في كلّ مادّة، سواءً ما تعلّق منها بالمَهارات أو الموضوعاتِ.
٧- تنفيذ خطط فرديّة للطّلبة من ذوي الاحتياجات التّعلّميّة الخاصّة؛ على أن يتمّ تحديد مستواهم بدقّة بعد إجراء اختبارٍ تشخيصيّ، وتعيين نوع الدّعم الذي يحتاجونه، وكذلك الاهتمام بالطّلبة الأكثر عُرضة للتّهميش.
٨- تعميق التّواصل مع أولياء الأمور من أجل إدارة جيّدة لبيئة التّعلّم المنزليّة، ومع جمعيّات المُجتمع المحلّي التي تُعنَى بتقديم الدّعم الدّراسيّ، وتوضيح الأدوار المنوطة بكلّ جهةٍ، ووضعهم في إطار البرامج التّعويضيّة التي تهدف إلى مساعدة التّلامذة الذين يحتاجون إلى دعم.
٩- إعطاء صلاحيّات مُوسّعة لمُديري المدارس بُغية توفير بيئة تعليميّة مُناسـبة، وتشكيل فريق مساندة مختصّ وذي خبرة يسهر على متابعة الخطط ويُجري مُراجَعات دوريّة شاملة.
١٠- تنفيذ برامج إعداد المعلّمين، وتمكينهم مهنيًّا، ودعمهم في تطبيق التّعلّم العلاجيّ، وتزويدهم بمصادرِ تعلّم تُسهّل عملَهم وتجعل نجاحَهم مُمكنًا.
١١- تحفيز التّلامذة، ورفع دافعيّتهم باستِمرار، وتعزيزهم عند أيّ تقدّم يُحرِزونه، والعمل الجادّ على معالجة الاتّجاهات السّلبيّة نحو التّعليم.
١٢- تنظيم برامج التّعليم المعجّل، حيث تختصر هذه البرامج عدّة سنوات من الدّراسة في بضعة أشهر، وتُخصّص للأطفال الذين توقّف تعليمهم لفترة طويلة لأسباب معيّنة.
١٣- توظيف تكنولوجيا التّعليم والتّطبيقات الإلكترونيّة والمنصّات الرّقميّة وتطوير المُمارَسات الصّفّيّة النّشِطة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا.
١٤- الأخذ بالحسبان أنّ الفاقد التّعليميّ يمكن أن يختلف من طالب لآخر، لذلك لا يجوز تطبيق الآليّة ذاتها على جميع التّلامذة، ويُنصَح بتصنيف الطّلّاب إلى مجموعات متقاربة المستوى لتيسير وتنظيم تقديم الدّعم.
ختامًا، إنّ العمل للحدّ من الفاقد التّعليميّ ليس بالأمر السّهل، فدُونه تحدّيات كبيرة لا بدّ من الانتباه لها والتّعامل معها بمسؤوليّة، إنّها مهمّة شاقّة ولكنّها مُمتِعة ومُجزِية.
* مُشرف تربويّ.